البلاغة العربية إلى أين.. بحث بقلم الأديب والشاعر/د. عبدالحميد دبوان
الاخوة القراء البحث طويل نوعا ما ولا استطيع تقسيمه لأنه بذلك يفقد قيمته أرجو المعذره
البلاغة العربية إلى أين
سؤال لابد من طرحه في بداية مقالنا هذا قبل أن نبدأ رحلة استعراض تاريخ البلاغة العربية باختصار ونستلهم من محطاتها الإبداعية عناصر التطور والرقي بهذا اللون من التعبير الأدبي , ونحاول أن نبعد عنها كل الظواهر السلبية التي رافقتها في رحلتها الطويلة .
فالبلاغة هي جوهر التعبير الأدبي ولؤلؤ معانيه التي يسمو بها إلى أفق من المعاني والصور الجمالية لم يكن ليصل إليها الأديب من دونها . وإذا ما استعرضنا تاريخ البلاغة نجد أنها في الأصل علم من علوم اللغة بها يقاس الأدب مظهرا حسنه من رديئه , وجميلة من قبيحه , بل هي كما قال الأستاذ أمين الخولي في كتابه : ( مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير الأدبي ) . روح الأدب , والأدب مادتها تعلم صنعه , وتبصر بنقده . وقد بدأت البلاغة العربية بالظهور عبر خطواتها الأولى في العصر الجاهلي ممتزجة بالنقد على شكل انتقادات فردية يوجهها الشعراء لبعضهم , فيستحسن هذا بيتا لصاحبه , ويستنكر ذاك بيتا أخر لغيره .
وقد ذكر مؤرخو الأدب حكايات مطولة عن هذه الإضاءات الفردية لبعض الجوانب البلاغية في الشعر وذلك لأن الشعر كان العصب الرئيسي للأدب في ذلك العصر .
يقول الجاحظ عن ذلك : ( كان العرب يصفون كلامهم في شعرهم وخطابتهم , ببرود العصب الموشاة , وبالحلل والديباج , والوشي وأشباه ذلك . وقد ورد عن رسول الله ( ص ) قوله : ( إن من البيان لسحرا ) وذلك تأكيد على أهمية تماثل المعنى مع اللفظ وإيحاآته .
وفي أخبار النابغة أنه كانت تضرب له قبة في سوق عكاظ ليحتكم الشعراء فيها إليه , فمن نوه به طارت شهرته في الأفاق , وكان في أثناء ذلك يبدي بعض الملاحظات على معاني الشعراء وأساليبهم , وقد ذكر الدكتور شوقي ضيف في كتابه ( البلاغة تطور وتاريخ ) أن النابغة فضل الأعشى على حسان بن ثابت , وفضل الخنساء على بنات جنسها , فثار عليه وقال له : أنا والله أشعر منك ومنها , فقال له النابغة : حيث تقول ماذا ؟ قال حيث أقول :
لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما
ولدنا بني العنقاء وابني محرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما
فقال له النابغة : إنك لشاعر لولا أن قللت عدد جفانك , وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك ؟ وقلت يقطرن من نجدة دما فدللت على قله القتل , ولو قلت يجرين لكان أكثر .
وكان كثير من الأدباء ينقحون في قصائدهم , ويجودون فيها حتى تخرج مستقيمة لا عيب فيها وسمي هؤلاء عبيد الشعر , عرف منهم زهير بن أبي سلمى , وولده كعب بن زهير وروايته الحطيئه .
ولقبوا شعراءهم بألقاب تدل على مدى إحسانهم في شعرهم ( كما يرون ) , فلقب بعض الشعراء بألقاب مثل " المهلهل , والمرقش , والمنحل , والنابغة والأخوة .... الخ "
ومع مجيء الإسلام وانتشاره بين ظهراني الجزيرة العربية , ترك القرآن أثراً كبيراً في البلاغة العربية وتطورها , فقد كان المحفز الأساسي للاتجاه نحو تدوين أصولها وقواعدها . عبر الاهتمام بالقرآن الكريم وإعجازه اللغوي بشكل أساسي ثم الالتفات إلى معانيه التي كانت تتدفق أمام أعينهم صوراً رائعة تقف متحدية في إعجازها كل البشر . ولكن هذا التطور لم يظهر في العصر الإسلامي لأن العرب كانوا منشغلين في تثبيت دعائم ملكهم , ونشر الإسلام خارج جزيرة العرب , لذلك بقيت البلاغة في إطارها النقدي البسيط وبقيت أحكامهم النقدية والبلاغية لا تخرج عن بعض الأحكام الفردية من مثل قولهم : " أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب , وزهير إذا رغب , والنابغة إذا رهب , والأعشى إذا طرب .
أو يقال : أشعر بيت في الغزل هو قول جرير :
إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحين قتلانا
أو أهجى بين قول جرير أيضاً :
فغض الطرف إنك من غير فلا كعبا بلغت ولا كلابا
ومع بداية العصر العباسي خطت البلاغة خطوات كبيرة على يد أبي هلال العسكري في كتابه : " الصناعتين " الذي اعتبر نقطة التحول من النقد البسيط الساذج إلى البلاغة التي بدأت ترتكز على قواعد , وبدأ الأدباء والنقاد يضبطون مسائلها وأصولها .
وتتابع التأليف في البلاغة بعد ذلك حتى وصلت إلى قمتها على يد الشيخ عبد القاهر الجرجاني مؤلف كتابي " أسرار البلاغة – ودلائل الإعجاز " . وقد استطاع أن يجمع في هذين الكتابين معظم مباحث البلاغة دون أن يقسهما إلى علوم المعاني والبيان والبديع كما فعل السكاكي بعد ذلك . وانقسم البلاغيون في هذه الفترة بين مدرستين هما مدرسة اللفظ التي يمثلها مسلم بن الوليد وأبو هلال العسكري الذي يقول في كتابه الصناعتين : وليس الشأن في إيراء المعاني , لأن المعاني يعرفها العربي والعجمي , والقروي والبدوي , وإنما هو في جودة اللفظ وصفائه , وكثرة طلاوته ومائه , مع صحة السبك والتركيب , والخلو من أود النظم والتأليف , وليس يطلب من المعنى إلا أن يكون صوابا .
ومن المعاصرين كان الأديب أحمد حسن الزيات الذي انحاز إلى جانب اللفظ في التعبير البلاغي ومدرسة المعنى هو الأساس وأن الألفاظ خادمة للمعنى لا أكثر . ومن هؤلاء ابن جني , وظهرت مدرسة ثالثة وفقت بين المدرستين ورأت أن المعاني لا تظهر إلا بثبوت اللفظ , ولا يمكن للفظ أن يقوي ويشتد إلا بالمعنى الذي يناسبه , فالكلام يناسب مقتضى الحال , وأشهر أصحاب هذه المدرسة هو الشيخ عبد القاهر الجرجاني :
ولكن البلاغة شهدت بعد ذلك حالة جمود والتدني على يد السكاكي ومن جاء بعده . فلقد حددوا البلاغة بهذه المقاييس وضبطوا أبحاثها بهذه الاعتبارات العقلية التي أزهقت روح البلاغة وأحالتها قواعد جامدة لا حياة فيها . وبذلك نشأ ذلك الجدل العنيف والنقاش الحاد في كتب البلاغة فأخرجها عن هدفها الفني , ومن يقرأ كتب المتأخرين وشروح التلخيص لكتاب السكاكي ( المفتاح ) يجد هذه الظاهرة واضحة جلية , ويجد أن أحكام المدرسة الكلامية أحكام بعيدة عن الروح الأدبية المعتمدة على الذوق الأدبي والإحساس الفني الصادق .
ومن شواهد الأثر الفلسفي لهذه المدرسة هو الإقلال من الشواهد والأمثلة الأدبية , وذلك لأن رجالها يهتمون بالتحديد المنطقي والحصر والتقسيم , وعندما يذكرون المثال أو الشاهد يأتون بأمثلة لا جمال فيها لأن صحة الشاهد عندهم أهم من الجمالية التي تكمن في معاينة وإسقاطاته على النفس ولذلك لم يوجهوا عنايتهم إليه , ومثال على ذلك ما ذكره السكاكي نفسه في معرض إيراده الشاهد حول رد العجز إلى الصدر فأتى بهذا المثال لقول الشاعر :
مشتهر في علمه وحلمه وزهده وعهده مشتهر
في علمه مشتهر وحلمه وزهده وعهده مشتهر
في علمه وحلمه وزهده مشتهر وعهده مشتهر
في علمه وحلمه وزهده وعهده مشتهر مشتهر
فأي معنى تحمله هذه الأبيات المرصوفة كأنها قطع خشبية لا روح فيها , وأين ذلك من قوله تعالى (( وجزاء سيئة سيئة مثلها )) أو قوله تعالى (( وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً )) ( والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس )
أو قول عمر بن أبي ربيعة :
واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد
فهذا كلام يقطر حسناً ويفيض بتألقه على كل حال ما حوله , بينما الآخر رصف كلام لا يحمل أي معنى حي .
وبقي الأمر على حاله من الجمود حتى عصرنا الحاضر الذي يشهد محاولات عديدة لإعادة الحياة إلى بلاغتنا وكان الإمام الشيخ محمد عبده أول المناضلين في هذه الساحة فقد أخذ يحي كتب السلف النافعة من مثل كتب الإمام عبد القاهر الجرجاني " دلائل الإعجاز " و " أسرار البلاغة " وتابعه الأستاذ على عبد الرزاق في كتاب له أسماه " أمالي علي عبد الرزاق " في علم البيان وتأريخه ثم جاء بعدهم مجموعة من أساتذة وشيوخ الأزهر حملت على عاتقها محاولات تخليص البلاغة من أدران الفلسفة وعلم المنطق الذي كرسه السكاكي والقزويني وأمثالهما .
ولكن تلك المحاولات باءت بالفشل منهج السكاكي سائداً في تدريس البلاغة في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا .
ولقد شهدت جامعة حلب ودمشق منذ السبعينات من القرن العشرين محاولات جديدة على يد بعض أساتذتنا طرحوا فيها وجهة نظرهم في البلاغة العربية ورأوا أن هذه البلاغة وصلت حدا من الجمود لم تعد فيه ذات نفع للتعبير بها عن جمالية اللغة العربية وحيويتها . وأصدر بعض الأدباء والنقاد كتباً وضعوا فيها تصوراتهم لنمط جديد من البلاغة يقوم بناؤه على الصورة بدلاً من التقسيم الثلاثي للبلاغة وهو التشبيه والاستعارة والكفاية . واستعاضوا عنها بمصطلح الصورة كما ورد في كتاب الدكتور نعيم اليافي ( مقدمة لدراسة الصورة الفنية ) وكتابه : ( تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث ) واستند الدكتور اليافي في دراساته لمصلح الصورة كما ورد في المفهوم الغربي والذي رأى فيه مصطلحاً يدرس الصورة عبر ثلاثة مناهج نفسي ورمزي وفني أو بلاغي .
والجدير بالذكر أن مصطلح صورة ليس جديداً على أدبنا العربي , فقد ورد في كتاب ( منهاج البلغاء وسراج الأدباء ) لأبي الحسن حازم القرطاجني وعرفها بأنها تتصل بالتخيل والمحاكاة ومن خلالهما تتشكل الصورة .
يقول القرطاجي : ( إن المعاني هي الصورة الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان , فكل شيء له وجود خارج الذهن , فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبر به هيأت تلك الصورة الذهنية في إفهام السامعين وأذهانهم . ) ولذلك نسأل أنفسنا ومن يعني بالبلاغة العربية لماذا نترك ما أبدعه أدباؤنا ونقادنا ونعزف عنه ونلجأ إلى ما قدم الغرب في هذا المجال . أفلا نبدأ بمراجعة حقيقية لبلاغتنا منطلقين فيها من تراثنا الي يزخر بالفهم الحقيقي للأدب العربي ومعاني لغتنا السمحة , ونترك ما كرسه السكاكي وإضرابه من جمود في هذه المصطلحات , ثم نستعين بعد ذلك بكل ما يفيدنا في هذا المجال حتى نصل إلى صورة ناضجة ومشرقة لبلاغة عربية تجعل من لغتنا كما أرادها القرآن لغة عربية عالمية .
د عبد الحميد ديوان
مراجع البحث
1- البلاغة تطور وتاريخ شوقي ضيف
2- دراسات بلاغية ونقدية – د أحمد مطلوب – دار الحرية بغداد 1980 م
3- مناهج التجديد في النحو والبلاغة والتفسير الأدبي أمين الخولي القاهرة 1947 .
4- البلاغة العربية في ثوبها الجديد / علم المعاني / د . بكري شيخ أمين
5- البلاغة العربية – نشأتها وتطورها فنونها وأفنانها – مشكلاتها وقضاياها – محاضرات ألقيت على طلاب السنة الثانية في جامعة حلب – قسم اللغة العربية – د . نعيم الباقي 1970
6- تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث - . نعيم اليافي .
7- الصناعيين – أبو هلال العسكري – تحقيق محمد علي البجادي – محمد أبو الفضل الابراهيم القاهرة 1952.
8- منهاج البلغاء وسراج الأدباء – أبو الحسن حازم القرطاجي – تحقيق محمد الحبيب الخوجه – توفي 1966.







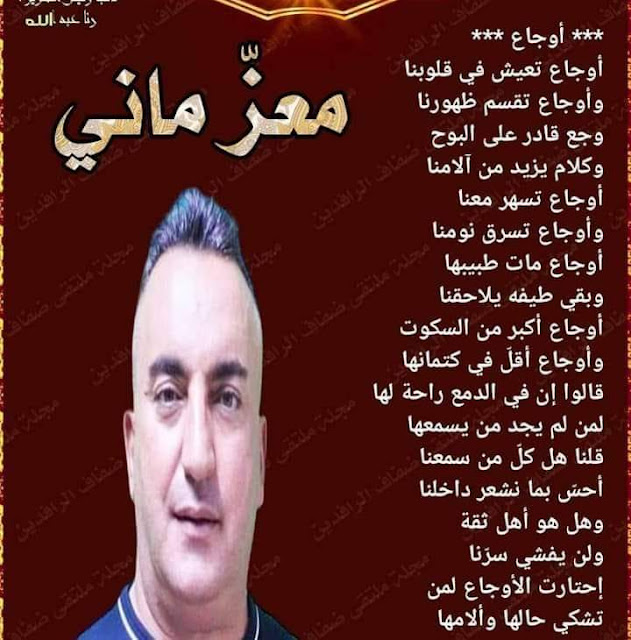

تعليقات
إرسال تعليق